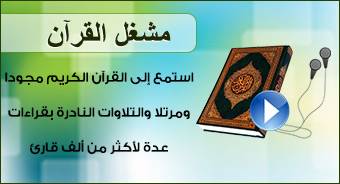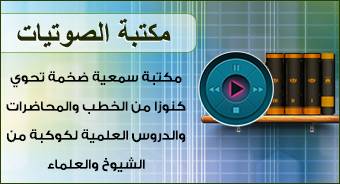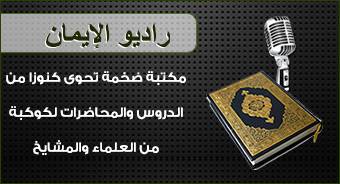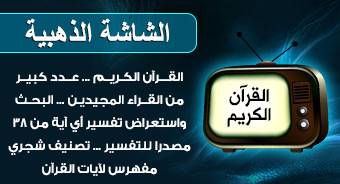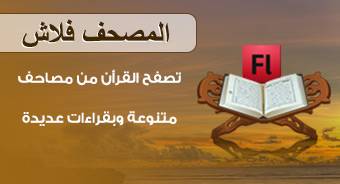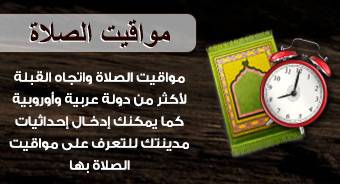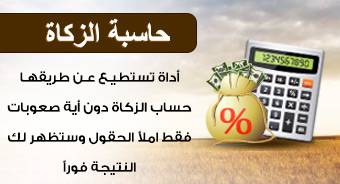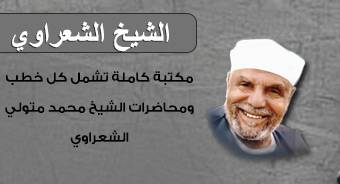.قال ابن عاشور:
.قال ابن عاشور:
{قُلْ إِنْ أدْرِي أقرِيبٌ ما تُوعدُون أمْ يجْعلُ لهُ ربِّي أمدا (25)}كان المشركون يكثرون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
{متى هذا الوعد} [النمل: 71]، و
{عن الساعة أيان مرساها} [الأعراف: 187]، وتكررت نسبة ذلك إليهم في في القرآن، فلما قال الله تعالى:
{حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا} [الجن: 24] الآية علِم أنهم سيعيدون ما اعتادوا قوله من السؤال عن وقت حلول الوعيد فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعيد عليهم ما سبق من جوابه.فجملة
{قل إن أدري أقريب ما توعدون} مستأنفة استئنافا بيانيا لأن القول المأمور بأن يقوله جواب لسؤالهم المقدر.والأمد: الغاية وأصله في الأمكنة.ومنه قول ابن عمر في حديث (الصحيحين):
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تُضمّر وجعل أمدها ثنية الوداع» (أي غاية المسابقة).ويستعار الأمد لمدة من الزمان معينة قال تعالى:
{فطال عليهم الأمد} [الحديد: 16] وهو كذلك هنا.ومقابلته ب(قريب) يفيد أن المعنى أم يجعل له أمدا بعيدا.وجملة
{عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا} في موضع العلة لجملة
{إن أدري أقريب ما توعدون} الآية.و
{عالم الغيب}: خبر مبتدأ محذوف، أي هو عالم الغيب والضمير المحذوف عائد إلى قوله:
{ربي}.وهذا الحذف من قبيل حذف المسند إليه حذفا اتُّبع فيه الاستعمال إذا كان الكلام قد اشتمل على ذكر المسند إليه وصفاته كما نبه عليه السكاكي في (المفتاح).و
{الغيب}: مصدر غاب إذا استتر وخفي عن الأنظار وتعريفه تعريف الجنس.وإضافة صفة
{عالم} إلى
{الغيب} تفيد العلم بكل الحقائق المغيبة سواء كانت ماهيات أو أفرادا فيشمل المعنى المصدري للغيب مثل علم الله بذاته وصفاته، ويشمل الأمور الغائبة بذاتها مثل الملائكة والجن.ويشمل الذوات المغيبة عن علم الناس مثل الوقائع المستقبلة التي يخبر عنها أو التي لا يخبر عنها، فإيثار المصدر هنا لأنه أشمل لإِحاطة علم الله بجميع ذلك.وتقدم ذلك عند قوله تعالى:
{الذين يؤمنون بالغيب} في سورة البقرة (3).وتعريف المسند مع تعريف المسند إليه المقدر يفيد القصر، أي هو عالم الغيب لا أنا.وفرع على معنى تخصيص الله تعالى بعلم الغيب جملة
{فلا يُظْهر على غيبه أحدا}، فالفاء لتفريع حكم على حكم والحكم المفرع إتمام للتعليل وتفصيل لأحوال عدم الاطلاع على غيبه.ومعنى
{لا يظهر على غيبه أحدا}: لا يُطلع ولا ينبئ به، وهو أقوى من يطلع لأن
{يظهر} جاء من الظهور وهو المشاهدة ولتضمينه معنى: يطلع، عدي بحرف
{على}.ووقوع الفعل في حيّز النفي يفيد العموم، وكذلك وقوع مفعوله وهو نكرة في حيّزه يفيد العموم.وحرف
{على} مستعمل في التمكن من الاطلاع على الغيب وهو كقوله تعالى:
{وأظهره الله عليه}[التحريم: 3] فهو استعلاء مجازي.واستثنى من هذا النفي من ارتضاه ليطلعه على بعض الغيب، أي على غيب أراد الله إظهاره من الوحي فإنه من غيب الله، وكذلك ما أراد الله أن يؤيد به رسوله صلى الله عليه وسلم من إِخبار بما سيحدث أو إطلاع على ضمائر بعض الناس.فقوله:
{ارتضى} مستثنى من عموم
{أحدا}.والتقدير: إلاّ أحدا ارتضاه، أي اختاره للاطلاع على شيء من الغيب لحكمة أرادها الله تعالى.والإِتيان بالموصول والصلة في قوله:
{إلاّ من ارتضى مِن رسول} لقصد ما تؤذن به الصلة من الإِيماء إلى تعليل الخبر، أي يطلع الله بعض رسله لأجل ما أراده الله من الرسالة إلى النّاس، فيُعْلم من هذا الإِيمان أن الغيب الذي يطلع الله عليه الرسل هو من نوع ما له تعلق بالرسالة، وهو غيب ما أراد الله إبلاغه إلى الخلق أن يعتقدوه أو أن يفعلوه، وما له تعلق بذلك من الوعد والوعيد من أمور الآخرة، أو أمور الدنيا، وما يؤيد به الرسل عن الإِخبار بأمور مغيبة كقوله تعالى:
{غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين} [الروم: 24].والمراد بهذا الإِطلاعُ المحقق المفيد علما كعلم المشاهدة.فلا تشمل الآية ما قد يحصل لبعض الصالحين من شرح صدر بالرؤيا الصادقة، ففي الحديث:
«الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوءة، أو بالإِلهام» قال النبي صلى الله عليه وسلم:
«قد كان يكون في الأمم قبلكم محدِّثون فإن يكُنْ في أمتِي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم» رواه مسلم.قال مسلم: قال ابن وهب: تفسير محدثون: ملهِمون.وقد قال مالك في الرؤيا الحسنة: أنها تسرُّ ولا تغرُّ، يريد لأنها قد يقع الخطأ في تأويلها.و
{مِن رسول} بيان لإِبهام
{منْ} الموصولة، فدل على أن ما صْدق
{من} جماعةٌ من الرسل، أي إلاّ الرسل الذين ارتضاهم، أي اصطفاهم.وشمل
{رسول} كلّ مرسل من الله تعالى فيشمل الملائكة المرسلين إلى الرسل بإبلاغ وحي إليهم مثل جبريل عليه السلام.وشمل الرسل من البشر المرسلين إلى الناس بإبلاغ أمر الله تعالى إليهم من شريعة أو غيرها مما به صلاحهم.وهنا أربعة ضمائر غيبة:الأول ضمير
{فإنه} وهو عائد إلى الله تعالى.والثاني الضمير المستتِر في
{يسلك} وهو لا محالة عائد إلى الله تعالى كما عاد إليه ضمير
{فإنه}.والثالث والرابع ضميرا
{من بين يديه ومن خلفه}، وهما عائدان إلى
{رسول} أي فإن الله يسلك أي يرسل للرسول رصدا من بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ومن خلفه رصدا، أي ملائكة يحفظون الرسول صلى الله عليه وسلم من إلقاء الشياطين إليه ما يخلط عليه ما أطلعه الله عليه من غيبه.والسّلْك حقيقته: الإِدخال كما في قوله تعالى:
{كذلك نسْلكه في قلوب المجرمين} في سورة الحجر (12).وأطلق السّلك على الإِيصال المباشر تشبيها له بالدخول في الشيء بحيث لا مصرف له عنه كما تقدم آنفا في قوله:
{ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا} [الجن: 17] أي يرسل إليه ملائكة متجهين إليه لا يبتعدون عنه حتى يبْلُغ إليه ما أوحي إليّه من الغيب، كأنّهم شبه اتصالهم به وحراستهم إياه بشيء داخل في أجزاء جسم.وهذا من جملة الحفظ الذي حفظ الله به ذكره في قوله:
{إنا نحن نزلنا الذّكر وإنا له لحافظون} [الحجر: 9].والمراد بـ
{مِن بين يديه ومن خلفه} الكناية عن جميع الجهات، ومن تلك الكناية ينتقل إلى كناية أخرى عن السلامة من التغيير والتحريف.والرصد: اسم جمع كما تقدم آنفا في قوله:
{يجد له شهابا رصدا} [الجن: 9].وانتصب
{رصدا} على أنه مفعول به لفعل
{يسلك} ويتعلق
{ليعلم} بقوله:
{يسلك} أي يفعل الله ذلك ليبلّغ الغيب إلى الرسول كما أرسل إليه لا يخالطه شيء مما يلبس عليه الوحي فيعلم الله أن الرسُل أبلغوا ما أوحي إليّه كما بعثه دون تغيير، فلما كان علم الله بتبليغ الرسول الوحي مفرعا ومسببا عن تبليغ الوحي كما أنزل الله، جعل المُسبب علّة وأقيم مقام السّبب إيجازا في الكلام لأن علم الله بذلك لا يكون إلاّ على وفق ما وقع، وهذا كقول إياس بن قبيصة:
وأقبلتُ والخطّيُّ يخطِر بيننا ** لأعلم منْ جبانُها مِن شجاعهاأي ليظهر من هو شجاع ومن هو جبان فأعلم ذلك.وهذه العلة هي المقصد الأهم من اطلاع من ارتضى من رسول على الغيب، وذكر هذه العلة لا يقتضي انحصار علل الاطلاع فيها.وجيء بضمير الإِفراد في قوله:
{من بين يديه ومن خلفه} مراعاة للفظ
{رسول} ثم جيء له بضمير الجمع في قوله:
{أن قد أبلغُوا} مراعاة لمعنى رسول وهو الجنس، أي الرسل على طريقة قوله تعالى السابق آنفا
{فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا} [الجن: 23].والمراد: ليعلم الله أن قد أبلغوا رسالات الله وأدوا الأمانة علما يترتب عليه جزاؤهم الجزيل.وفهم من قوله:
{أن قد أبلغوا رسالات ربهم} أن الغيب المتحدث عنه في هذه الآية هو الغيب المتعلق بالشريعة وأصولها من البعثثِ والجزاء، لأن الكلام المستثنى منه هو نفي علم الرسول صلى الله عليه وسلم بقرب ما يوعدون به أو بعده وذلك من علائق الجزاء والبعث.ويلحق به ما يوحى به إلى الأنبياء الذين ليسوا رسلا لأن ما يوحى إليهم لا يخلو من أن يكون تأييدا لشرع سابق كأنبياء بني إسرائيل والحواريين أو أن يكون لإِصلاح أنفسهم وأهليهم مثل آدم وأيوب.واعلم أن الاستثناء من النفي ليس بمقتض أن يثبت للمستثنى جميع نقائض أحوال الحكم الذي للمستثنى منه، بل قصارى ما يقتضيه أنه كالنقض في المناظرة يحصل بإثبات جزئي من جزئيات ما نفاه الكلام المنقوص، فليس قوله تعالى:
{إلاّ من ارتضى من رسول} بمقتض أن الرسول يطلع على جميع غيب الله، وقد بين النوع المطلع عليه بقوله:
{ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم}.وقرأ رويس عن يعقوب
{ليُعلم} بضم الياء وفتح اللام مبنيا للمفعول على أنّ
{أنْ قد أبلغوا} نائب عن الفاعل، والفاعل المحذوف حذف للعلم به، أي ليعلم الله أن قد أبلغوا.الواو واو الحال أو اعتراضية لأن مضمونها تذييل لجملة
{ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم} أي أحاط بجميع ما لدى الرسل من تبليغ وغيره، وأحاط بكل شيء مما عدا ذلك، فقوله:
{وأحاط بما لديهم} تعميم بعد تخصيص ما قبله بعلمِه بتبليغهم ما أرسل إليهم، وقوله:
{وأحصى كل شيء عددا} تعميم أشمل بعد تعميممٍ مّا.وعبر عن العلم بالإِحصاء على طريق الاستعارة تشبيها لعلم الأشياء بمعرفة الأعداد لأن معرفة الأعداد أقوى، وقوله:
{عددا} ترشيح للاستعارة.والعدد: بالفك اسم لمعدود وبالإدغام مصدر عدّ، فالمعنى هنا: وأحصى كل شيء معدودا، وهو نصب على الحال، بخلاف قوله تعالى:
{وعدّهم عدّا} [مريم: 94].وفرق العرب بين المصدر والمفعول لأن المفعول أوغل في الاسمية من المصدر فهو أبعد عن الإِدغام لأن الأصل في الإِدغام للأفعال. اهـ.
 .قال ابن عطية في الآيات السابقة:
.قال ابن عطية في الآيات السابقة:
{وألّوِ اسْتقامُوا على الطّرِيقةِ لأسْقيْناهُمْ ماء غدقا (16)}الضمير في قوله:
{استقاموا} قال أبو مجلز والفراء والربيع بن أنس وزيد ابن أسلم والضحاك بخلاف عنه: الضمير عائد على قوله:
{من أسلم} [الجن: 14]، و
{الطريقة} طريقة الكفر، لو كفر من أسلم من الناس
{لأسقيناهم} إملاء لهم واستدراجا. وقال قتادة وابن جبير وابن عباس ومجاهد الضمير عائد على
{القاسطين}. والمعنى على طريقة الإسلام والحق لأنعمنا عليهم، وهذا المعنى نحو قوله:
{ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم} [المائدة: 65]، وقوله:
{لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم} [المائدة: 66]. وهذا قول أبين لأن استعارة الاستقامة للكفر قلقة. وقرأ الأعمش وابن وثاب
{وأن لوُ} بضم الواو. وقال أبو الفتح هذا تشبيه بواو الجماعة اشتروا الضلالة، والماء الغدق: هو الماء الكثير. وقرأ جمهور الناس
{غدقا} بفتح الدال، وقرأ عاصم في رواية الأعشى عنه بكسرها. وقوله تعالى:
{لنفتنهم} إن كان المسلمون فمعناه لنختبرهم، وإن كان القاسطون فمعناه لنمتحنهم ونستدرجهم، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حيث يكون الماء فثم المال، وحيث يكون المال فثم الفتنة، ونزع بهذه الآية، وقال الحسن وابن المسيب وجماعة من التابعين: كانت الصحابة سامعين مطيعين، فلما فتحت كنوز كسرى وقيصر وثب بعثمان فقتل وثارت الفتن. و
{يسلكه} معناه يدخله، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الياء أي
{يسلكه} الله، وقرأ بعض التابعين
{يُسلكه} بضم الياء من أسلك وهما بمعنى، وقرأ باقي السبعة
{نسلكه} بنون العظمة، وقرأ ابن جبير
{نُسلِكه} بنون مضمومة ولام مكسورة. و
{صعدا} معناه شاقا، تقول فلان في صعد من أمره أي في مشقة، وهذا أمر يتصعدني، وقال عمر: ما تصعدني شيء كما تصعدني خطبة النكاح، وقال أبو سعيد الخدري وابن عباس: صعد جبل في النار، وقرأ قوم
{صُعُودا} بضم الصاد والعين، وقرأ الجمهور بفتح الصاد والعين.وقرأ ابن عباس والحسن بضم الصاد وفتح العين، وقال الحسن: معناه لا راحة فيه، ومن فتح الألف من
{أن المساجد لله} جعلها عطفا على قوله:
{قل أوحي إليّ أنه} [الجن: 1]، ذكره سيبويه، و
{المساجد} قيل أراد بها البيوت التي هي للعبادة والصلاة في كل ملة.وقال الحسن: أراد كل موضع سجد فيه كان مخصوصا لذلك أو لم يكن، إذ الأرض كلها مسجد لهذه الأمة. وروي أن هذه الآية نزلت بسبب تغلب قريش على الكعبة، حينئذ فقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم: المواضع كلها لله فاعبده حيث كان وقال ابن عطاء:
{المساجد}: الآراب التي يسجد عليها، واحدها مسجد بفتح الجيم، وقال سعيد بن جبير: نزلت الآية لأن الجن قالت يا رسول الله: كيف نشهد الصلاة معك على نأينا عنك: فنزلت الآية يخاطبهم بها على معنى أن عبادتكم حيث كنتم مقبولة.وقال الخليل بن أحمد: معنى الآية، ولأن
{المساجد لله فلا تدعوا} أي لهذا السبب، وكذلك عنده
{لإيلاف قريش} [قريش: 1]
{فليعبدوا} [قريش: 3] وكذلك عنده
{وأن هذه أمتكم أمة} [الأنبياء: 92، المؤمنون: 52]. و
{المساجد} المخصوصة بينة التمكن في كونها لله تعالى فيصح أن تفرد للصلاة والدعاء وقراءة العلم، وكل ما هو خالص لله تعالى، وأن لا يتحدث بها في أمور الدنيا. ولا يتخذ طريقا، ولا يجعل فيها لغير الله نصيب، ولقد قعدت للقضاء بين المسلمين في المسجد الجامع بالمرية مدة، ثم رأيت فيه من سوء المتخاصمين وأيمانهم وفجور الخصام وعائلته ودخول النسوان ما رأيت تنزيه البيت عنه فقطعت القعود للأحكام فيه. وقوله عز وجل:
{وأنه لما قام عبد الله} يحتمل أن يكون خطابا من الله تعالى، ويحتمل أن يكون إخبارا عن الجن، وقرأ بعض القراء على ما تقدم
{وأنه} يفتح الألف، وهذا عطف على قوله:
{أنه استمع} [الجن: 1]، والعبد على هذه القراءة قال قوم: هو نوح، والضمير في
{كادوا} لكفار قومه، وقال آخرون، هو محمد، والضمير في
{كادوا} للجن. المعنى أنهم
{كادوا} يتقصفون عليه لاستماع القرآن، وقرأ آخرون منهم
{وإنه لما قام} بكسر الألف، والعبد محمد عليه السلام، والضمير في
{كادوا} يحتمل أن يكون للجن على المعنى الذي ذكرناه، ويحتمل أن يكون لكفار قومه وللعرب في اجتماعهم على رد أمره، ولا يتجه أن يكون العبد نوحا إلا على تحامل في تأويل نسق الآية، وقال ابن جبير: معنى الآية، إنما قول الجن لقومهم يحكون، والعبد محمد صلى الله عليه وسلم.والضمير في
{كادوا} لأصحابه الذين يطوعون له ويقتدون به في الصلاة، فهم عليه لبد. واللبد الجماعات شبهت بالشيء المتلبد بعضه فوق بعض، ومنه قول عبد بن مناف بن ربع: البسيط:
صافوا بستة أبيات وأربعة ** حتى كأن عليهم جانيا لبدايريد الجراد سماه جانيا لأنه يجني كل شيء، ويروى جابيا بالباء لأنه يجبي الأشياء بأكله، وقرأ جمهور السبعة وابن عباس:
{لِبدا} بكسر اللام جمع لِبدة، وقال ابن عباس: أعوانا. وقرأ ابن عامر بخلاف عنه وابن مجاهد وابن محيصن:
{لُبدا} بضم اللام وتخفيف الباء المفتوحة وهو جمع أيضا. وروي عن الجحدري:
{لُبُدا} بضم اللام والباء. وقرأ أبو رجاء:
{لِبدا} بكسر اللام، وهو جمع لابد فإن قدرنا الضمير للجن فتقصفهم عليه لاستماع الذكر، وهذا تأويل الحسن وقتادة و
{أدعو} معناه أعبده، وقرأ جمهور السبعة وعلي بن أبي طالب:
{قال إنما}، وهذه قراءة تؤيد أن العبد نوح، وقرأ عاصم وحمزة بخلاف عنه:
{قال إنما} وهذه تؤيد بأنه محمد عليه السلام وإن كان الاحتمال باقيا من كليهما. واختلف القراء في فتح الياء من
{ربي} وفي سكونها. ثم أمر تعالى محمدا نبيه عليه السلام بالتبري من القدرة وأنه لا يملك لأحد
{ضرا ولا رشدا}، بل الأمر كله لله. وقرأ الأعرج
{رُشُدا} بضم الراء والشين، وقرأ أبيّ بن كعب
{لكم غيا ولا رشدا}. وقولهم
{من دونه} أي من عند سواه. و(الملتحد): الملجأ الذي يمال إليه ويُركن، ومنه الإلحاد الميل، ومنه اللحد الذي يمال به إلى أحد شقي القبر.
{إِلّا بلاغا مِن اللّهِ ورِسالاتِهِ ومنْ يعْصِ اللّه ورسُولهُ فإِنّ لهُ نار جهنّم خالِدِين فِيها أبدا (23)}اختلف الناس في تأويل قوله:
{إلا بلاغا}: فقال الحسن ما معناه أنه استثناء منقطع، والمعنى لن يجيرني من الله أحد
{إلا بلاغا}، فإني إن بلغت رحمني بذلك، والإجارة: للبلاغ مستعارة إذ هو سبب إجارة الله تعالى ورحمته، وقال بعض النحاة على هذا المعنى هو استثناء متصل. والمعنى لن أجد ملتحدا
{إلا بلاغا}، أي شيئا أميل إليه وأعتصم به إلا أن أبلغ وأطيع، فيجبرني الله. وقال قتادة: التقدير لا أملك
{إلا بلاغا} إليكم، فأما الإيمان أو الكفر فلا أملكه. وقال بعض المتأولين
{إلا} بتقدير الانفصال، و(أن) شرط و(لا) نافية كأنه يقول: ولن أجد ملتحدا إن لم أبلغ من الله ورسالته، و
{من} في قوله:
{من الله} لابتداء الغاية. وقوله تعالى:
{ومن يعص الله} يريد الكفر بدليل الخلود المذكور. وقرأ طلحة وابن مصرف،
{فإن له} على معنى فجزاؤه أن له، وقوله:
{حتى إذا رأوا}، ساق الفعل في صيغة الماضي تحقيقا لوقوعه. وقوله تعالى:
{من أضعف} يحتمل أن تكون
{من} في موضع رفع على الاستفهام والابتداء و
{أضعف} خبرها، ويحتمل أن تكون في موضع نصب ب
{سيعلمون}، و
{أضعف} خبر لابتداء مضمر، ثم أمره تعالى بالتبري من معرفة الغيب في وقت عذابهم الذي وعدوا به، والأمد: المدة والغاية، و
{عالم} يحتمل أن يكون بدلا من
{ربي} [الجن: 20] ويحتمل أن يكون خبر ابتداء مضمر على القطع، وقرأ السدي:
{عالم الغيب} على الفعل الماضي ونصب الباء، وقرأ الحسن:
{فلا يظهر} بفتح الياء والهاء
{أحدٌ} بالرفع. وقوله تعالى:
{إلا من ارتضى من رسول} معناه فإنه يظهره على ما شاء مما هو قليل من كثير، ثم يبث تعالى حول ذلك الملك الرسول حفظة
{رصدا} لإبليس وحزبه من الجن والإنس، وقوله تعالى:
{ليعلم} قال قتادة معناه
{ليعلم} محمد أن الرسل
{قد أبلغوا رسالات ربهم} وحفظوا ومنع منهم. وقال سعيد بن جبير: معناه يعلم محمد أن الملائكة الحفظة، الرصد النازلين بين يديه جبريل وخلفه
{قد أبلغوا رسالات ربهم}. وقال مجاهد
{ليعلم} من كذب وأشرك أن الرسل قد بلغت.قال القاضي أبو محمد: وهذا العلم لا يقع لهم إلا في الآخرة، وقيل معناه
{ليعلم} الله رسالته مبلغة خارجة إلى الوجود لأن علمه بكل شيء قد تقدم، وقرأ الجمهور:
{ليعلم} بفتح الياء أي الله تعالى. وقرأ ابن عباس:
{ليُعلم} بضم الياء، وقرأ أبو حيوة:
{رسالة ربهم} على التوحيد، وقرأ ابن أبي عبلة:
{وأحيط} على ما لم يسم فاعله، وقوله تعالى:
{وأحصى كل شيء} معناه كل شيء معدود، وقوله تعالى:
{ليعلم} الآية، مضمنه أنه تعالى قد علم ذلك، فعلى هذا الفعل المضمر انعطف
{وأحاط}،
{وأحصى} والله المرشد للصواب بمنه. اهـ.